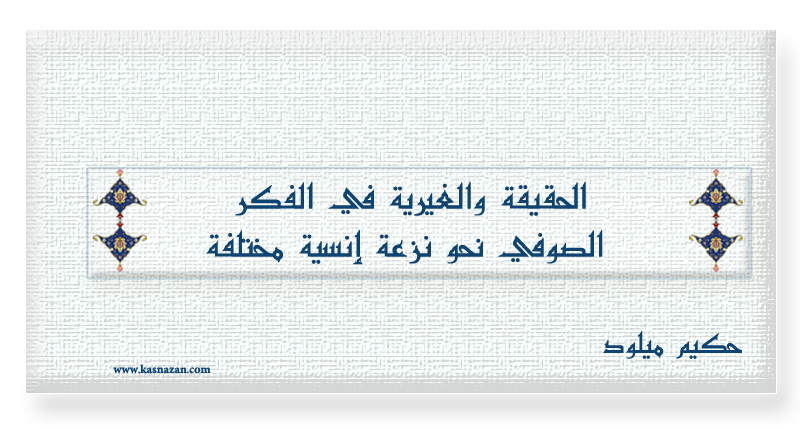حكيم ميلود
جامعة الشلف
ارتبطت التجربة الصوفية في ، السياق الإسلامي , بانفتاح متفرَد على آفاق معرفية ودينية متميزة . إذ أن علاقتها مع الدين كمؤسسة هي علاقة اتصال وانفصال ، علاقة امتداد وانقطاع . ففي الوقت الذي تتقاطع فيه مع التراث الديني كبعد أساسي في تأسيس هذه التجربة، تحاول أن تقدم تصوَرها الخاص المبني على قراءة للعمق الخفي والمستتر لهذا الدين, الذي لا يعود مهمًا, فقط كأوامر ونواهي, وعادات وعبادات, ولكن كتجربة مسلكية تمثل رغبة محرقة في الاتصال مع الله, وفي الذهاب من الظاهر إلى الباطن, من المألوف إلى الخارق, وذلك لا يتم إلا باستيفاء شروط, واختبار امتحانات عسيرة. من هنا كانت التجربة الصوفية طرحاً مختلفا, وفريداً, ورؤية للوجود تحمل الكثير من الغموض والغرابة, لأنها تترك للجوانب المدهشة في هذا الكون وفي الكائن سحرها, ودهشتها.
من جهة أخرى لا تتأسس التجربة الصوفية, في علاقتها العمودية مع الله (أو المقدس), أو فبي علاقتها الأفقية مع الوجود وكائناته, في البعد الديني فقط, ولكنها تجربة معرفية, تجربة في النظر والسلوك, تطرح نظامها الخاص, وتقدم أدواتها التي تختبر بها المجهول.
خصائص المعرفة الصوفية :
تتميز التجربة الصوفية, على المستوى المعرفي، بمجموعة من الخصائص لعل أهمها هو اعتبارها المعرفة علاقة مباشرة بين الذات, والشيء المعروف.
وبذلك هي لا ترى إلى الوجود باعتباره خارجاً يمكن معرفته بوسائل خارجية, ولكنه داخل لابد من التوغل فيه لإدراكه. وثنائية الخارج – الداخل هذه, جعلت التصوف يميز بين مسارين لاكتشاف هذين المجالين أولهما العقل الذي يشكل أداة معرفة العالم الخارجي, وثانيهما القلب لمعرفة العالم الداخلي (الباطن).
وثمة فروق كبرى بين معرفة القلب ومعرفة العقل. فمعرفة القلب إدراك مباشر للشيء, وأما معرفة العقل فإدراك جانب من جوانبه. الأولى حال يتحد فيها العارف والمعروف , أما الثانية فإدراك العلاقة بين العارف والمعروف, أو لمجموعة من العلاقات , الأولى تجربة ومشاهدة , أما الثانية فحكم تجريدي. فالمعرفة الصوفية إلهامية تشرق في النفس, وليست كسباً يتم بالجهد والاختيار. ومن هنا كانت التجربة الصوفية بدئية لا تعلَل بالعقل بل العقل هو الذي يعلل بها. إنها حركة بين القلب اللامتناهي , بشوقه وحبه, والمطلق اللامتناهي. أما العقل فحركة متناهية تتجه نحو اللامتناهي. (1)المعرفة الصوفية إذاً تجربة حدسية ,يتلقى فيها الصوفي الإلهام الذي يكشف له أبعاده العميقة المحتجبة, وفي لوقت نفسه, يطل على عوالم مجهولة. لذلك هي علم لدني, لا يمكن تعليله بأدوات العقل الذي طرده التصوف من مجاله. وفي التصوف ” يقتضي القول بملكة خاصة”غير العقل المنطقي, هي التي يهتم بها هذا الاتصال (بين العبد والرب), فيها تتأحد الذات والموضوع, وتقوم فيها البواده واللوائح واللوامع مقام التصورات والأحكام والقضايا في المنطق العقلي. والمعرفة فيها معاشة لا متأملة. ويغمر صاحبها شعور عارم بقوى تصطدم فيه تغمره كفيض من النور الباهر, أو يغوص فيها كالأمواج العميقة. ويبدو له أيضا أن قوى عالية قد غزته وشاعت في كيانه الروحي .(2)كما أن هذه المعرفة في بعدها الأول “حال” يعانيه الصوفي.
ولتلك الحال من الصفات والخصائص ما يكفي في تميزها عن غيرها ممَا تعانيه النفس الإنسانية من أحوال أخرى.(3 ) ذلك أنها تتجه نحو الفناء في موضوعها الذي يسلبها, أي المطلق, اللامتناهي الذي يناديها, ويتجلى في قلب الصوفي فيحصل الكشف, الذي يخطف صاحبه من عالم الحس إلى الغياب, الذي هو حضور في حضرة اللامتناهي فـ ” التصوف تجربة تتجه فيه “الإرادة” الإنسانية نحو موضوعها الذي تتعشقه وتفنى فيه, فتعرفه النفس عن طريق الاتحاد به معرفة ذوقية(4).
يترتب عن هذا التقسيم للمعرفة إلى معرفة العقل ومعرفة القلب, وانتصار التصوف للثانية باعتبارها تجربة وذوقاً وكشفاً, تمييز آخر له أهمية بين الظاهر والباطن.
الظاهر والباطن :
يقول أبو نصر السراج الطوسي : إن العلم ظاهر وباطن… والأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح وهي العبادات والأحكام… وأما الأعمال الباطنة فكأعمال القلوب وهي المقامات والأحوال… ولكل عمل من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبيان وفهم وحقيقة ووجد… فإذا قلنا : علم الباطن أردنا بذلك علم أعمال الباطن التي هي الجارحة الباطنة, وأما إذا قلنا علم الظاهر أشرنا إلى علم الأعمال الظاهرة التي هي الجوارح الظاهرة وهي الأعضاء.(5)
هذا التقسيم أتاح للتجربة الصوفية أن تتميز ضمن أفق مغاير, فإذا كان الظاهر سهل الإدراك والفهم, فإنه لا يمثل إلا السطح, وهو الذي يشترك في معرفته العموم. أما الباطن فليس متاحاً وهو متوغل في احتجابه. ويستلزم العبور من السطح إلى العمق الذي لا يتجلى إلا للذين يحيون امتحان تلك التجربة. ويرقون في مدارج المحو والمجازفة, حتى ينالوا قبسا من ذلك السَر.
تجسدت جدلية الظاهر, الباطن في التجربة الصوفية من خلال تحويل لمسارات تناول الدين والمعرفة. إذ تميزت النزعة الصوفية في كونها لا تقف عند مظاهر الدين كتشريع فقط, أو عند الرسوم كما فعل الفقهاء, ألذ خصوم المتصوفة, ولكن قرأت الدين قراءة باطنية, وعبرت من سطح النصوص, خاصة النص القرآني, إلى عمقها فطرحت, إشكالية التأويل كمقابل للتفسير. وبذلك غامرت بدفع الدين في تجربة الانفتاح والتعدد في القراءة. “فإذا كانت ثقافة الظاهر, بحسب المؤسسة الدينية السياسية الاجتماعية, محدودة, ومن السهل تحديدها, فان ثقافة الباطن غير محدودة ويتعذر تحديدها(6 )بل إن شرط استمرارية الدين وتواصله مع التحولات التي يحياها الإنسان, هو القدرة على تجاوز ظاهره إلى أعماقه الغنية بإمكانات التأويل حتى لا ينغلق الدين داخل السياج الدوغمائي, فيتحول إلى مجرد مظاهر شكلية, أو ممارسات تعبدية لا تحمل الغنى الروحي, إذ “الظاهر ليس إلا صورة من صور الباطن. وبما أن الباطن لانهاية له ,فلا يمكن أن تحده صورة واحدة,بل لا يمكن أن تحده الصور.(7)
إن هذه التصورات التي بلورت نظرية في المعرفة الصوفية لم تقف عند هذه الحدود, بل تجاوزتها إلى مستوى آخر, فظهر زوج آخر هو الحقيقة والشريعة. ولا ريب أن هذا الزوج يشكل نقطة مفصلية في الخطاب الصوفي, لأنه تتويج لكل المفاهيم السابقة, وصهر لها, فيما سيشكل أهم مميز.
الشريعة والحقيقة :
يرى المتصوف السني القشيري أن : الشريعة أمر للعبد بالتزام العبودية والحقيقة مشاهد الربوبية أي رؤيته إياها بقلبه.(8 ) ويقول مصطفى العروسي في شرح هذا الكلام في قوله أمر للعبد بالتزام العبودية أي بحيث لا يرى حيث نهي ولا يفقد حيث أمر لان الشريعة هي ما شرعها الله من الأحكام أمرا ونهياً على لسان رسوله.(9 )ترتبط الشريعة إذن بالأحكام, أي الأوامر والنواهي ويؤكد ذلك القشيري حيث يقول : “الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالى .(10 ) وهي “قيام من العبد بما أمره(11). أما الحقيقة فهي دوام النظـر إليه و شهـود لما قضي الله به (12) . ومن هنا نجد أن الشريعة والحقيقة مرآة ذات وجهين , إحداهما تمثل السطح والظاهر, والأخرى تمثل العمق والباطن. الأولى مرتبطة بالدين كممارسة وعبادة, والثانية كانكشاف وإشراق, وتجل بعد الرقي في العبادات إلى درجة الشفافية القصوى. إحداهما من طور يشترك فيه الجميع, والثانية من طور آخر يخص به الله أصفياءه الذين لا يعبدونه طمعاً وخوفاً إنما حباً. الحقيقة هي ثمرة المحبة والذوق. وقد حاول القشيري أن يخفف من حدة تباينهما, وهو كان يقف موقف المدافع عن التصوف من هجمات الفقهاء, فقال : الشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطن الشريعة وهما متلازمان لا يتم أحدهما إلا بالآخر فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة. وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصول فمن لا حقيقة له لا شريعة له. ومن لا شريعة له لا حقيقة له. لان الحقيقة اصل الإيمان والشريعة القيام بالأركان. فمن عرف الحق ولم يعبده تعرض للخسارات, ومن لم يعرفه استحالت منه الطاعات. (13)وعلى الرغم من محاولة إيجاد التوفيق بينهما كما يفعل القشيري, من باب الرد على من يحاولون التشكيك في التصوف, ويعتبرونه تجاوزًا للعبادات, وإسقاطاً لها, إلا أن الحقيقة احتلت عند العرفانيين مكانة أسمى لأن الشريعة متناهية ترتبط بالعالم, والحقيقة لا متناهية لأنها ترتبط بغيب الألوهية – غيب الكون.(14) يمكن أن نقول أيضا أن الاختلاف بينهما يكمن في طبيعة كل منهما, ومقاصدهما. فإذا كان يغلب على الشريعة جانب القواعد الدينية – التعبدية الطقسية, وتقف عند الحدود المرسومة ضمن تصور مؤسساتي, وأحياناً سلطوي للدين, كما هو مكرس ومتداول, ومقبول. فإن الحقيقة تغلب التجربة وتغامر باختراق الحدود, والذهاب في امتحان الأقاصي, أين يجازف العارف بكل شئ إلى درجة الانخطاف أو الجنون والضياع , مقابل هذه الحقيقة التي يبتعد فيها لينال قبساً من الله اللامتناهي. وإذا كانت الشريعة تقدم الدين كيقين, فالحقيقة تقدمه كدهش وحيرة وقلق واغتراب… ونجد القشيري يوضح المسألة أكثر حين يقول : وإنما وقعت التفرقة بينهما للغلبة في حال العابد والعارف ولما كان العابد يغلب عليه الوقوف مع الأعمال وإتقانها وإخلاصها سمي صاحب شريعة ولما كان العارف يغلب عليه حال الحق ويرى أن جميع ما هو فيه من فضله سمي صاحب حقيقة. فقد تبين أن بينهما اجتماعاً وافتراقاً بالاعتبار.(15) هذا الافتراق بالاعتبار هو الذي يميز الحقيقة كمعطى أو شئ مكتسب, أو معرفة من الدرجة الثانية, وإنما كتجربة وسفر دائم ومقيم إننا كلما سافرنا أبعد عرفنا أقل كما يرى لاوتسو. وهذا ما يفرق بين اليقين المطمئن, والقلق المتسائل والحائر . لان العلم المستقر هو الجهل المستقر كما يقول النفري . ومن ثم ما يهم هو البحث عن الحقيقة لا الوصول إليها .
ومن هنا تأتي قيمة الطريقة . فالشريعة أن تعبده , والحقيقة أن تشهده والطريقة أن تقصده (16) وللطريقة معنيان سفر من الظاهر إلى الباطن , من الشريعة إلى الحقيقة , من العالم إلى الله. والثاني تبدل في الصفات وتحول داخلي, يهيئان النفس ويمكنانها من رؤية الله والاتصال به(17) ذلك أن المتصوف لا ينفك من كونه مسافرا والذي, بتيقنه من الأمر الذي ينقصه , يعرف جيداً أن الذي يبحث عنه ليس شيئاً معيناً أو مكاناً محدداً وانه لا يمكن البقاء هنا أو الرضا بـ هذا … فهو يواصل إذن سيره وترك الأثر في ذاته في صمت وانكتاب(18) .
الحقيقة كاصطلاح صوفي تمثل محرق تجربة المعرفة والسلوك, إذ هي مدار كل ما يحياه الصوفي في وجوده, ومن هنا فهي ليست مجرد مقابل للشريعة, ولكنها تصور للكون ورؤيا تعبر من المألوف والعادي إلى الخارق والمحتجب والخفي. وهي حركة في المكان والوقت, وعدم تسليم بالتقليد الديني كممارسة تعبدية, أو وسيلة لها مقاصد واضحة ومعلومة. سواء قصدت إلى تنظيم الأمور الدنيوية أو الأخروية في إطار منظومة الجزاء والمعاقبة, الجنة والنار. إنها تجربة تعصف بالصوفي, وتدخله في حالات اقرب إلى الفقد والتوحد مع المطلق, لا هدف لها. إلا هذه الحالة التي تمثل الرغبة المحرقة في التوحد والانصهار والفناء في الله. و من استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسماً ولا طللاً… يقال أنه فني عن الخلق وبقي بالحق(19) .
الحقيقة والتأويل :
إن ارتباط المعرفة عند الصوفية بالتجربة الالهامية, وبالفيوض الذوقية أين يكون القلب هو محل التجليات الإلهية, والكشف الذي لا يحصل إلا بمفارقة العبد لعالم الحس والأشياء, وغيبته عن نفسه, وحضرته في وجود الحق, الذي يخطفه ويسلبه. جعل الحقيقة مسارا وسفرا, إذ هي ليست شيئاً معطى, ولكنها استحقاق يناله العارف بعد معاناة ومكابدة, وبعد ترقيه في المعارج الروحية إذ أن التجليات الإلهية على قلوب العارفين هي التي تمكنهم من القدرة على التأويل وفهم حقيقة أعيان الأشياء وأسرارها الباطنة. وإذا كان هذا التجلي على باطن نفس العارف أو على قلبه يتدرج مع رقيه في معراجه الصوفي, فإن علوم الباطن تزداد مع رقيه في هذا المعراج. وكلما رقى في معراجه درجة زاد التجلي في باطنه على قدر ما ينقص من ظاهره, حتى يصل إلى حالة الفناء, أو الكشف التام, فيغمر هذا التجلي كل ظاهر الصوفي, أو لنقل يتحول الظاهر إلى باطن, وتنتفي الثنائية التي مردها إلى عالم الحس والمادة(20) .
إن العبور من ظاهر الوجود إلى باطنه يفترض التأويل, ذلك لان الباطن لا يمكن التعبير عنه باللغة العادية, من هنا شكل الصوفية لغة خاصة لها معجمها المتميز الذي يعبر عن هذه الإشارات والتلويحات بطريقة رمزية كثيراً ما تستغلق على غير المتبحرين في المعرفة, إن الحالة التي يحياها الصوفي في معراجه المعرفي هي أقرب إلى الحلم والهلوسة. وتماسه مع الخفي يدخله إلى المناطق التي تضيق عنها العبارة, أي في المناطق اللامقولة واللامنطوقة. يقيم المتصوف من كل هذه الظواهر النفسية والجسدية وسيلة تهجي اللامنطوق فهو يتحدث عن شيء ما لا يمكنه أن يعبر بألفاظ, ويلجأ إلى وصف يجتاز الاحساسات ويسمح بقياس المسافة الكائنة بين التداول العام لهذه الألفاظ والحقيقة (21) .
إن مدار محنة الصوفي هي كيف يسافر بين العالمين : الهنا والهناك, وكيف يجد التوازن. هذه التجربة التي دفع بعضهم ثمنها غالياً, كما حصل للحلاج الذي قال كلاماً من هناك للذين هنا فاتهم بالكفر , وهو كان مغلوباً على حاله , فانياً عن صفاته الإنسية والدنيوية. وهناك من عاش تجربة الجنون والجذب والدروشة. وهي ضريبة المعرفة التي تحرق من يقترب منها كثيراً. لهذا يحتاج الصوفي إلى تأويل الحقيقة التي رآها كرؤيا الخيال الذي هو برزخ بين الظاهر والباطن. إذ الوجود بمراتبه المختلفة يمثل حجاباً على الحقيقة الإلهية, كما تمثل الصورة في الحكم غطاء على المعنى أو الرمز الذي يختفي وراءها, ومن ثم فالوجود يحتاج إلى تأويل يتماثل مع تأويل الأحلام عبوراً من الظاهر إلى الباطن (22) .
يصبح التأويل إذن ضرورة على المستوى الوجودي وعلى المستوى الديني. فعلى مستوى الوجود كل الكائنات والمخلوقات هي من مظاهر التجلي الإلهي , وبالتالي يلزم العبور من الموجود للتعرف على الواجد. وعلى المستوى الديني يكون النص القرآني, الذي يعتبر الوجود المكتوب , وكلمة الله هو المقصود بالتأويل, وذلك بالذهاب من سطحه اللغوي إلى عمقه الأنطولوجي. ومن هنا يكون التأويل هو معرفة مآل الشيء وحقيقته, وهو أصله الذي منه بدأ وإليه يعود. التأويل على مستوى الوجود- هو النفاذ من الظاهر الحسي إلى الباطن الروحي , والتأويل – على مستوى النص – هو تجاوز إطار اللغة العرفية الإنسانية في محدوديتها واصطلاحيتها إلى إطار اللغة الإلهية في إطلاقها ودلالتها الذاتية(23 ) .
إن التأويل على مستوى النص القرآني لا يكتفي بمعرفة أسرار اللغة والبلاغة والنحو والأحكام, وهذا ضروري, ولكن يتعدى ذلك إلى محاولة إدراك الأبعاد الخفية, لان الكلمات أمة من الأمم كما يقول ابن عربي, الذي نجد في تنظيراته تناولاً ثرياً لهذه الجوانب ابتداءً من رمزية الحروف إلى معضلات أخرى كالتنزيه والتشبيه, والمحكم, والمتشابه… أين يقدم الخطاب الصوفي قراءة مختلفة للنص القرآني عن تلك التي قدمها المتكلمون والفقهاء والفلاسفة. لان المتصوفة كان يدركون أن ” الحقيقة ليست في ما يقال , فيما يمكن قوله, وإنما هي في ما لا يقال, في ما يتعذر قوله. أنها في الغامض, الخفي, االلامتناهي(24) .
وسنرى أهمية التأويل عندما نشير إلى انفتاح التصوف على الآخر, بنزعة تسامحية قل نظيرها في تاريخ الثقافات, وكل هذا كان نابعاً من إدراك للحقيقة واليقين, ولكن كحال وكبحث, أين يمثل اللاوصول شرطها الأساسي. ونابعاً أيضاً من عمل التأويل الذي يعني السؤال المتواصل. إذ لا يعود النص لديني والقرآني, المقدس والمؤسس, نصاً مغلقاً ومنتهياً, ولكن يصبح نصاً مفتوحاً على القراءات اللامنتهية, وعلى الفهم المختلف, والخلاَق باستمرار، الفهم الذي ليس مرتبطاً بتحليل ظاهر النص بالأدوات العلمية المكتسبة والمحروسة بسلطة العقل, ولكنه الفهم المأخوذ بالتجربة والمسلكية, بالذوق والحدس والإلهام والكشف… الانفتاح على الآخر في الفكر الصوفي (نزعة الأنسنة) :
إن مدار التجربة الصوفية يقوم على استحالة استنفاذ الحقيقة واستكناهها, وسبر أغوارها, لأنها مما لا يوصف ولا يقال, ذلك أنها أكبر من قدراتنا. وأقصى ما يستطيعه العارف هو التأويل عن طريق, الرمز والإشارة أو كتابتها على جسده الذي ينطق بأحواله فيتحول إلى علامة تحمل بصمة المطلق, وهو امتحان يحياه العارف بالذهول والشرود, والزهد والسفر والجنون, وأعراض أخرى كالجذب, وهو في ذلك يكون مصغياً لذبذبات اللانهائي, ولتموجات بحر الأسرار, التي يمتزج معها في رقصها الكوني ذلك لان حقيقة معرفته (الله) لا يطيقها الخلق, ولا ذرة منها : لان الكون بما فيه يتلاشى, عند ذرة من أول باد يبدو من بوادي سطوات عظمته. فمن يطيق معرفة من يكون هذا صفة من صفاته ؟ فلذلك قال القائل : ما عرفه غيره ولا احبه سواه : لأن الصمدية ممتنعة من الإحاطة والإدراك. قال عز وجل : ولا يحيطون بشيء من علمه( 25) . لهذا فكل الخلق حائرون فيه, يبحثون عنه, وهو تختلف تجلياته لكل واحد منهم. فمعرفته ليست على سبيل اليقين, لكنها أقرب إلى الظن, لأنه يتجلى لكل واحد بحسب استعداد أحواله, ومدى ابتعاده في مدارج الرقي, ومعارج الكشف, لأن الحقيقة ذوق… ينتج عن هذا التصور أن الحقيقة هي ملك للجميع, وللاأحد. وبذلك لا يحق لأي كان أن يزعم أنه يمتلك اليقين, ولكن أقصى ما يستطيع الإشارة إليه هو تجربته الشخصية مع اليقين والحقيقة, كما عايشها. من هنا يظهر الدين لا كمؤسسة لها سلطة امتلاك الحقيقة واليقين, ولكن كتجربة شخصية بين العبد والخالق. وهذا يعتبر أهم ما خلخل به الفكر الصوفي المرجعية الأرثذوكسية, الفقهية, وبذلك حصل التمييز بين معنيين للدين “المعنى الروحي المنزه المتعالي – والمعني القانوني, الرسمي السلطوي, أو الذي يخلع السلطات على السلطات السياسية.( 26) ولا شك أن هذا التمييز بين البعد الروحي للدين والبعد الأيديولوجي السلطوي هو أهم ما يميز التجربة الصوفية, ويمثل شرط انفتاحها على الآخر غير المسلم.
المبدأ الثاني الذي خلخلته التجربة الصوفية هو الهوية ككينونة مغلقة, تتعامل مع الآخر (الغير) إما استدراجاً له للانصهار فيها, أو للتماهي معه . وكلا التعاملين لا يصدران عن محبة, ولكن إما عن رغبة في السيطرة, أو عن ضعف. أما في التجربة الصوفية فإن الهوية, على العكس, تفتح مستمر. فالذات حركة دائمة في تجاه الآخر. ولكي تبلغ الذات الآخر لابد من أن تتجاوز نفسها, أو لنقل : لا تسافر الذات في اتجاه كينونتها العميقة, إلا بقدر ما تسافر في اتجاه الآخر وكينونته العميقة. “ففي الآخر تجد الذات حضورها الأكمل. الأنا هي, على نحو مفارق, اللاأنا. والهوية, في هذا المنظور, هي كمثل الحب – تخلق باستمرار(27 ) والعارف بقدر تجرده من ذاته وصفاته, يصل إلى التوحد مع المطلق (الله). من هنا فلا وجود للأنا, هناك فقد الهو. أو الأنا آخر بتعبير رامبو “وبدلاً من الكوجيتو الديكارتي : أفكر, إذا أنا موجود ( أنا نفسي) يقول الكوجيتو الصوفي : أفكر إذا أنا آخر (أنا لا أنا)(28) إن انفجار الأنا, وخلخلة مركزيتها, يمنح للعارف القدرة على استقصاء اللامرئي, والخروج من وجوده للتوحد مع المطلق. وبقدر شعوره أنه أجنبي عن ذاته, يكون توحده مع الله. حتى يصل إلى الذروة, فيقول أنا الله كما حصل للحلاج. أو يتجسد في الشطح كما تمثله تجربة البسطامي.
وهذا الخروج على الأنا هو أيضا انفتاح على الغير, وتقبل لاختلافه الديني والمذهبي. لهذا نجد في التجربة الصوفية بوادر نزعة إنسية عظيمة، والمقصود بهذه النزعة ، ذلك الموقف المفتوح للإنسان كي يمارس حريته في التفكير والأيمان والاختلاف. وهي المزج بين الثقافات والحضارات وصهرها في بوتقة ما وبيئة ما(29) وهي بذلك تتجاوز حدود الأديان والطوائف والقوميات والأعراق لكي تصل إلى الإنسان في كل مكان(30 ) . هكذا فالموقف الإنسي هو الذي يجعل الإنسان مركز التفكير، وذلك لا يتم إلا بتحرير هذا الإنسان من سطوة التصور الديني الدوغمائي، المغلق، الذي يعتبر فيه الإنسان مجرد عبد لأله متعال، مطلوب منه العبادة وتنفيذ الأوامر، والانتهاء عن النواهي. لهذا عندما يتحول الدين إلى مؤسسة ويتحالف مع السلطة فهو يذهب في هذا الاتجاه. وينفي بذلك ما يسميه أركون حقوق الروح. يقول : نلاحظ أن الأديان المرسخة تحمل في طياتها إنكارا أو نفيا قويا جدا لحقوق الروح، وذلك عندما تربط بين التحديد الدوغمائي والحصري للحقيقة وبين اللاهوت الذي يدعو إلى الانخراط في الحرب العادلة (أو الجهاد) ضد الكفار(31) .
إن الفكر الصوفي انزل الله من تعاليه، وجعل التجربة الإنسانية محل التجلي القدسي، وأصبحت العلاقة بين الإنسان والله علاقة محبة، لا علاقة خوف، وعلاقة توحد لا علاقة تبعية، لذلك فالبديل للانغلاق على الذات ، واعتبارها مالكة للحقيقة، هو الانفتاح على الآخر، وفهم تجربته، وقبول الاختلاف معه. أو تأويل الاختلاف كما فعل ابن عربي قي نظرته للديانات الأخرى، أو ما يمكن تسميته مع أركون النزعة الإنسية الدينية.
الانفتاح على الآخر عند ابن عربي :
إن تأويل ابن عربي للنصوص الدينية، جعله يبتعد في مناطق جلبت له تأليب الفقهاء، واتهامه بالزندقة، لكن عندما نتأمل عميقا في نظريته (الصوفية) نكتشف هذه القدرة المدهشة على استكناه النص والتوغل في عتماته ولا شك أن التجربة الشخصية (الصوفية) التي عاشها، وظرفه التاريخي أتاحا له هذه الفتوحات، فهو عاش في الأندلس في لحظة حضارية عرفت أوج التبادل الحضاري والمعرفي، والانفتاح على الثقافات الأخرى، والديانات المختلفة. وهو قد تأثر بكل التيارات التي كانت موجودة في عصره، وكل ما وصله من علوم متباينة، وان موسوعته الفتوحات المكية خير شاهد على هذه التأثيرات.
من أطرف تصورات ابن عربي هي نظرته إلى ديانات الآخرين، واختلافها بروح تسامحية قل نظيرها. وذلك في إطار نظريته في التأويل الرمزي. فهو فرق بين التجليات الوجودية والتجليات الاعتقادية، فالكون والمخلوقات كلها مظاهر التجلي الإلهي، هذا التجلي المستمر والمتغير بلا انقطاع فلو لم يظهر التبدل في العالم لم يكمل العالم، فلم تبق حقيقة إلهية إلا وللعالم استناد إليها، على أن تحقيق الأمر عند أهل الكشف أن عين تبدل العالم عين التحول الإلهي في الصور(32) . فالكون والوجود يتحولان بتحول التجليات الإلهية ، كما أن التجليات تكون بحسب استعداد البشر واختلافاتهم، والإنسان الكامل هو الذي يدرك ثبات الحقيقة رغم اختلاف تجلياتها في الصور المختلفة. ومن هنا فمعرفة المتصوفة له تمييزهم عن غيرهم فالعارف الكامل يعرفة في أي صورة يتجلى فيها، وفي كل صورة ينزل فيها، وغير العارف لا يعرفه إلا في صورة معتقده، وينكره إذا تجلى له في غيرها(33) وهو هنا يشير إلى اختلاف التجليات انطلاقا من اختلاف الشرائع.
والغريب عند ابن عربي انه لم يهتم بأسس الاختلاف والتنوع بقدر ما حاول اكتشاف البنية التي توحد تلك الأديان والشرائع، أن ما يهمه ليس توزعها الإيديولوجي والجغرافي، ولكن بنيتها الأساسية الجوهرية التي تجد كامل تفسيرها في فكرة التجلي، وفعلا، فالاعتقادات والأديان تشكل مظاهر وتجليات لمعاني الألوهية(34) ولهذا كما يقول ابن عربي فان كل طائفة قد اعتقدت في الله أمرا ما إن تجلى لهم في خلافه أنكرته، فإذا تجلى لهم في العلامة التي قررتها تلك الطائفة مع الله قي نفسها أقرت به… فاختلفت التجليات لاختلاف الشرائع.35 يميز ابن عربي أيضا ” بين الذات المتعالية وبين ما يسميه باسم إله المعتقدات أي الإله الذي يصنعه المعتقد في نفسه ويجعل له علامة فيها ويعتقد فيها على أنها الحقيقة المطلقة للألوهية(36) .
ويقول في هذا الشأن : واله المعتقدات مصنوع للناظر فيه فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفسه. ولهذا يذم معتقد غيره، ولو انصف لم يكن له ذلك إلا أن صاحب هذا المعبود الخاص جاهل بلا شك في ذلك لاعتراضه على غيره فيما اعتقده في الله إذ لو عرف ما قال الجنيد : لون الماء لون إنائه ، لسلم لكل ذي اعتقاد ما اعتقده ، وعرف الله في كل صورة وكل معتقد فهو ظان ليس بعالم.
فاله المعتقدات تأخذه الحدود، وهو الإله الذي وسعه قلب عبده، فان الإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء وعين نفسه(37) إن اله المعتقدات متعدد بتعدد الأديان، ولكن العارف يبحث فيما وراء الأديان. وهمه هو الله. لهذا فهو يعبده خارج الانغلاق داخل تجل واحد ، ولا يعتبر الآخرين كافرين لأنهم يعبدونه فيما تجلى لهم فيه ” فكل عابد أو معتقد ما عبد إلا الله في الحقيقة، وما اعتقد إلا فيه أي كانت الصورة التي عبدها التي اعتقد فيها الألوهية(38) ومن هنا لا بد من النظر إلى باطن الأديان لا ظاهرها ، والعبور من التعدد الظاهري إلى الوحدة الباطنية، التي هي وحدة الذات الإلهية وبذلك يتم تجاوز الصراعات الدينية والمذهبية، لهذا يقول بن عربي : إياك أن تعتقد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه. فكن في نفسك هيولي لصور المعتقدات كلها، فان الله أوسع واعظم من أن يحصره عقد دون عقد(39) .
وهذا ليس غريبا على الإسلام دين المحبة والتسامح ، وعلى المتصوفة إذ أن مبدأ التسامح يجد الراقي تعبيره الرقى في الفكر الصوفي، لأنه يؤسس التسامح تأسيسا معرفيا لا أخلاقيا، وذلك انطلاقا من انه لا يعرف الحق إلا بالحق لهذا كان البسطامي يدعو الله لجميع الناس، ويلتمس أن يبسط رحمنه على النوع البشري كله ، ويود لو يشفع للناس كافة ، لا للمذنبين من الأمة الإسلامية وحدهم، بل لكل الخطاة بكل دين دانوا .
____________
الهوامش :
1 – أدونيس، علي احمد سعيد : الثابت والمتحول، تأصيل الأصول، دار العودة، بيروت، ط3، 1962، ص 95.
2 – عبد الرحمن بدوي : تاريخ التصوف الإسلامي، من البداية حتى القرن الثاني هجري، وكالة المطبوعات، الكويت، ط 2، 1987، ص 18.
3 – أبو العلا حفيني، التصوف : الثورة الروحية في الإسلام، دار المعارف، القاهرة مصر، ط، 1963، ص 13.
4 – المرجع نفسه، ص 17.
5 – أبو نصر السراج الطوسي : اللمع تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، مطبعة المثنى، بغداد، العراق، دار الكتب الحديثة، القاهرة 1960، ص 3 ع.
6 – أدونيس : الصوفية والسوريالية، دار الساقي، بيروت، 1992، ص 156.
7 – أدونيس : الثابت والمنقول، ج 2، ص 91 – 92.
8 – عبد الكريم بن هوازن القشيري : الرسالة، وعلى هامشها حاشية السيد، العروسي، جامع الدرويشية، دمشق، ص 93.
9 – 13 : القشيري : المرجع نفسه.
14 – أدونيس : الصوفية والسوريالية، ص 94.
15 – 16 : القشري : الرسالة، ص 94.
17 – أدونيس : الثابت والمتحول 200، ص 93.
18 – انظر،Michel de Certeam : La fable mystique, Ed. Gallimard. 1982, p. 411
19 – القشري : الرسالة، ص 94.
20 – نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند ابن عربي، ميشال دوساتور.
21 – الخطاب الصوفي : تر. محمد شوقي الزين، مجلة كتابات معاصرة، العدد 44 تموز- آب 2001، ص 53.
22- نصر حامد : المرجع نفسه، ص 221.
23 – نفسه، ص 313.
24 – أدونيس : الصوفية والسوريالية، ص 198.
25 – السراج الطوسي : اللمع، ص 56.
26 – محمد أركون : قضايا في نقد العقل الديني، ترجمة، هاشم صالح، دار الطليعة بيروت، ط 2، 2000 ، ص 237.
27 – أدونيس : الصوفية والسوريالية، ص 166.
28 – أدونيس : النظام والكلام، دار الأدب، بيروت، ط1، 1993، ص 7.
29 – محمد أركون : الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، ترجمة، هاشم صالح، م.و.ك، الجزائر 1993 -2113.
30 – محمد أركون : نزعة الإنسنة في الفكر العربي، دار الساقي، بيروت 1997، ص 29.
31 – محمد أركون : نفسه، ص. ع.
32 – ابن عربي : الفتوحات المكية، دار صادر بيروت، (د. ت) ج3، ص 457.
33 – ابن عربي : نفسه، ج 3، ص 132.
34 – منصف عبد الحق : الكتابة والتجربة (نموذج محي الدين بن عربي)، منشورات عكاظ، الرباط، ط1 1988، ص 198.
35- ابن عربي : الفتوحات، ج1، 66.
36 – منصف عبد الحق : المربع نفسه، ص 200.
37 – ابن عربي : نصوص الحكم، تحقيق أبو العلاء عفيفي، دار الكتاب العربي.
38 – نصر حامد أبو زيد : فلسفة التأويل، ص 409.
39 – ابن عربي : نصوص الحكم، ج1، ص 113.
40 – ابن عربي : ترجمان الأشواق، دار صادر، بيروت 1966، ص 43-44.
41 – نصر حامد أبو زيد : الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، المغرب – لبنان، 2000، ص 255.
42 – عبد الرحمان بدري : تاريخ التصوف الإسلامي، ص 29.
المصدر : موقع مجلة حوليات التراث .
http://annales.univ-mosta.dz/texte/ap04/13miloud.htm