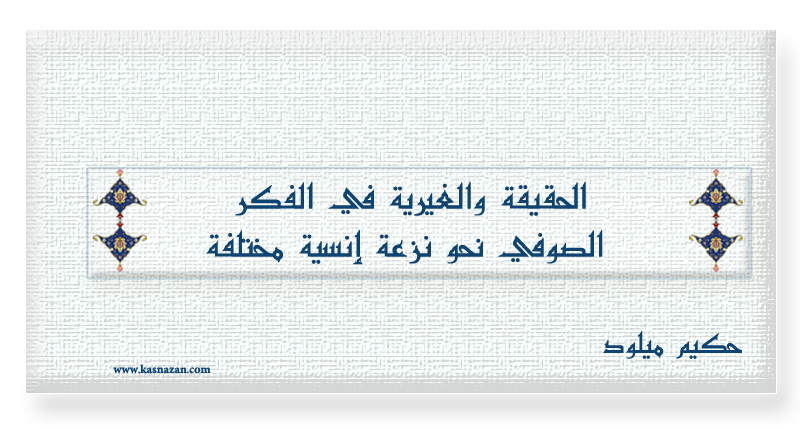محمد حسين
تراثنا الصوفي معين لا ينضب من العطاء، وما أحسب أمة من الأمم تملك ما بين أيدينا من ذلك البناء الشامخ الذي تعامل مع النفس الإنسانية، تعامل الخبير بأمراضها، العليم بأدوائها، المحيط بسبل علاجها؛ حتى ليخال للمرء أحيانًا وهو يقرأ في الإحياء أو مدارج السالكين أن المصنِّف قد اطلع على خبيئة نفسه وما يعانيه من أمراض ومشكلات، وشرع يصف له بدقة كيف يعالج أمراضها ويتغلب على مشكلاتها.
والعجب كل العجب أن نملك هذا التراث الشامخ والبناء الراسخ، ثم لا نعطيه ما يستحقه من تدبر وتأمل، ومن الاهتداء به في ظلمات المادة التي تحيط بنا من كل جانب، بل إن البعض للأسف أهال عليه التراب ونَعَتَه بما ليس فيه، فحال بين بعض من لا قَدَمَ راسخًا لهم في العلم وعطاء لا ينفد، وهل أبشع من أن يختزل إحياء الغزالي – ذلك السفر الذي لا نظير له في تراث الأمة – في أنه مستودع أحاديث ضعيفة؟!
أو أن يُحال بين المسلمين ومنازل الهروي بدعوى أنه حلولي، أو أن تُرْمى الصوفية كلها بكافة طرقها وذاخر تراثها وعظيم عطائها بأنها سبب تخلف الأمة! هكذا دون تفرقة بين غثٍّ وسمين وبين تِبر وتبن.
ورغبة منا في أن تصل الأمة بتراثها الصوفي؛ لتحيي قلوبًا كادت تصدأ، ولتنعش نفوسًا كادت تموت، سنقف مع بعض من هذا التراث لنضع أيدي الذين حُرِموا ذلك العطاء على منبع ثَرٍّ ومدد روحي وإيماني لا نظير له.
ووقفتنا هنا مع حكم “ابن عطاء”، ولا نحسب كلمات علم من أعلامنا الصوفية حظيت بما حظيت به الحكم من شروح وتفسيرات حتى بلغت شروحها العشرات ما بين قديم ومعاصر، فمن ابن عباد وابن عجيبة وحتى الغزالي والقرضاوي، كلٌّ ذهب يستقي من عطاء الحكم وينهل من نبعها الفيَّاض، فتعددت الشروح وتعددت الأفهام لكنها جاءت في جملتها؛ لتثبت أننا أمام كلمات نورانية ألهم الله بها قائلها فجمعت في إيجاز عجيب بين بلاغة اللفظ وسهولته وعمق المعنى وأهميته، ويحسب البعض أن الحكم عطاء روحي إيماني فحسب، وأنها أبعد ما تكون عن مخاطبة العقل أو إصلاح خلل الفكر. لكن من يتدبرها سيجد أنها وإن بلغت الذّروة في مخاطبة النفس وتهذيبها وتنبيه القلوب وإحيائها، فإنها كذلك عالجت جوانب من خلل الفكر وسقيم العقل. فهي وإن أشارت إلى التوكل إشارات يكاد من لا بصيرة له يظنها إهمالاً للأسباب كاملاً، وجهلاً بنواميس الكون شاملاً، فإنها تُلْفت في إشارات أخرى إلى ما يوقظ الغافل من غفلته، ويوقظ صاحب الأماني الكاذبة بلا عمل من غفوته.
وانظره – رحمه الله – يقول:”أَرِح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك”
فتظن إن لم ترزق فهمًا صحيحًا ورؤية ثاقبة أنه يأمر بترك الأسباب بالكلية والركون إلى الدعة والاتصاف بالاتكالية، لكنه كي لا يشرد بك فهمك ويختلط عليك نظرك يوقفك وقفة قوية فيقول: “الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية” أي: إياك أن تفهم من أمره لك بترك التدبير أنه يخصك على الركون للراحة وانتظار النجاة، إنما يخاطب من يفهم فيأمره أن يفرِّغ قلبه من التعلق بغير ربه، فلا تركن إلى الأسباب وإنما اركن إلى المسبب، فما تفعل الأسباب إن لم يشأ مسببها؟
ولكن انتظارك نتيجة لم تقم بأسبابها أمل فارغ وأماني زائفة: ” ولا تكن عبد المنى فإن المنى بضاعة المفاليس ” إنه مذهب اشتهر به ابن عطاء أن يفرغ القلب من غير الله تعالى فما يبقى فيه إلاّه، فينصحك أن “لا تقعد نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال”.
لكنه لا يرضى لك أن يكون الوهم قائدك فيحذرك: “ما قادك شيء مثل الوهم” وهو إذ يأمرك بالتواضع الذي هو شعار أهل الطريق حتى ليخال لك ـ إن لم تكن أهل بصيرة ـ أنه ينصحك بالتنازل عن عزة نفسك؛ إذ يقول: “ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى نفسه فوق ما صنع، وإنما المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع” إذا به يردك بعدها مباشرة لما يريده منك من تواضع فيقول: “التواضع الحقيقي ما كان ناشئًا عن شهود عظمته وتجلي صفته”أي أن شهود عظمة الله سبحانه وتجلي صفته تجعل العبد يدرك مجرد كونه عبدًا ذليلاً أمام الواحد القهار، فلا يملك إلا التواضع. ثم إنه يريد لك عزًّا لكنه عز حقيقي لا وهمي فبذلك دل الخبير: “إذا أردت عزًّا لا يُغني فلا تستعزنَّ بعزٍّ يغني” ويصل بك إلى درجة من العز رفيعة؛ إذ ينصحك: “لا تمدنَّ يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك” ويرتقي بك إن رمت أن تكون مع العارفين فيذكرك بأنه: “ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيئته، فكيف لا يستحيي أن يرفعها لخليقته؟!” ويعلمك أن تترفع عن الأخذ من الخلائق كي لا يكون لأحد عليك مِنَّة؛ لأنه يرى أن: “العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان” ويتحدث عن الصحبة في حكمتين بليغتين ناصحًا إياك أن تصحب من يرفعك لا من ينزل بك، ومن يعلو بصحبته قدرك لا من تنزل بصحبته مكانتك، فيقول – رحمه الله -: “لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله” ويحذرك من الاغترار بخسَّة همة الناس وانحطاط أقدارهم أن تظن أن ذلك يعني رفعة قدرك وعلو همتك، فيقول: “ربما كنت مسيئًا فأراك الإحسان منك صحبتك لمن هو أسوأ منك حالاً” أما كلامه عن النفس فهو كلام طبيب حاذق وخبير صادق، يقف بك مع حقيقة ذاتك كي لا يخدعك ظن الناس بك، فينبهك إلى أن: “الناس يمدحونك بما يظنون فيك، فكن ذامًّا لنفسك لما تعلم منها” ويحذرك أن تكون من ذلك الصنف المخدوع، فيقول لك: “أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظنِّ ما عند الناس” ويعلمك كيف تتعامل مع ثناء الخلق بالثناء على الخالق سبحانه: “إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثنِ عليه بما هو أهله” أي أَثْن على الله بما يستحق مقابلة لثناء الناس عليك بما لا تستحقه. وينصحك بأنه خير لك أن تنشغل بمعالجة أمراضك بدلاً من انشغالك بقضايا حجبت عنك معرفتها؛ لأن: “تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خيرٌ من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب” ويعلمك أن: “أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها”. لأن الذي يرضى عن نفسه سوف لا يطمع إلى تحقيق المزيد من الارتفاع والعلو فيرضى لنفسه بالدونية. ويقف مع الوقت وأهميته وقفات تنمُّ عن شخصية وثَّابة غير متواكلة ولا خانعة، فيحذِّر السالك أولاً من تأجيل الأعمال وتسويفها حتى يجد الفراغ مبينًا أن ذلك من حيل النفس الخبيثة، فيقول: “إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس ، ذلكم أن كل وقت له عمله فكيف يأتي الفراغ؟ ” ثم يؤكد: “لا تترقب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه” أي لا تنتظر أن يفرغ قلبك من كل شيء حتى تسير إلى ربك؛ لأنك إن فعلت ما تم لك ذلك، ولكن قم بما تقدر عليه في وقتك وحالك الذي أنت فيه، وكما قيل: سيروا إلى الله عرجًا ومكاسير، وبيَّن أن الأعمار لا تقاس بعدد أيامها وساعاتها بل بما أنجزه الإنسان خلالها.
“رُبَّ عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورُبَّ عمر قليلة آماده كثيرة أمداده” وصدق – رحمه الله – فقد تُوفِّي الشافعي في الرابعة والخمسين وقد ملأ طباق الأرض علمًا، وتوفي عمر بن عبد العزيز في الثامنة والثلاثين بعد أن حكم الأمة عامين وأشهرًا فتحقق خلالهما ما لا يحققه آخرون في عشرات الأعوام، وتُوفِّي النووي في الثانية والأربعين وقد ترك تراثًا يعجز أحدنا أن يقرأه بتدبر وفهم بله أن يكتب مثله. وهو يحذِّر رحمه الله من اتساع الوقت والفراغ من الشواغل، ثم التفريط في هذا وعدم الفرار إليه سبحانه فيقول: “الخذلان كل الخذلان – أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه، وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه” ذلكم أنك قد لا تقل شواغلك بعد هذا، وقد لا تقل عوائقك سوى هذه المرة، هكذا تعامل أهل الطريق مع الوقت فهو رأسمالهم الذي إن فقدوه فما له من عوض، وما لَهم لا يفعلون وقد قال رائدهم صلى الله عليه وسلم: “نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ”. رواه البخاري والترمذي تُرى لو تعاملت الأمة مع قيمة الوقت كما تعاملوا أمَا تبدَّل الحال وتغيَّر المسار. وبعد فكانت هذه وقفات مع إمام جليل ومع فيض نبعه غزير.. والسعيد من نصح فانتصح. والله من وراء القصد.
______
المصدر : موقع اسلام اون لاين .
http://islamonline.net/arabic/arts/2001/01/article2.shtml